قانون انتخاب أعضاء مجلس النُوَّاب: دراسة نقديَّة في ضوء الإصلاح الإداري
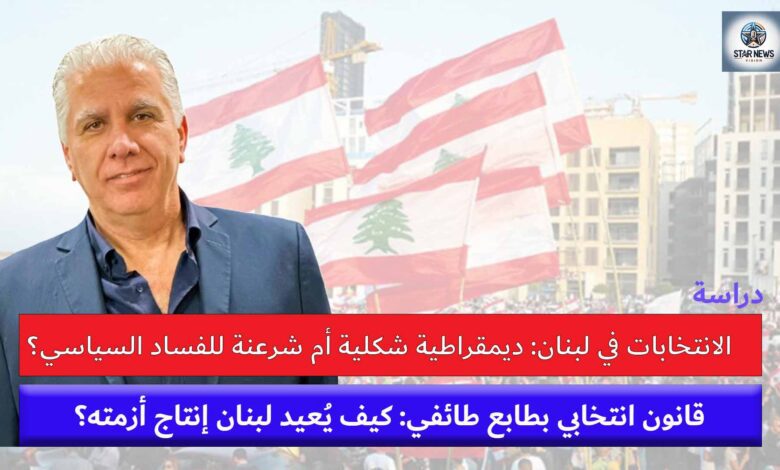
د.بول الحامض
حين يتحوّل القانون إلى عقبة أمام الدولة
في دولة يتأرجَح نظامها بين الديمقراطية الشكليَّة والطائفيَّة العميقة، يُعتَبَر القانون الإنتخابي واحِدًا من أبرز مجالات الصِّراع بين القوى السياسيَّة. فالقانون الذي كان من المُفترَض أن يُنظِّم التنافُس السياسي ويُعَبِّر عن الإرادة الشعبيَّة، أصبَحَ في الحالة اللبنانية أداة لإعادة إنتاج النُّفوذ وتعميق الإستقطاب الطائفي. وفي الوقت الذي يُطالِب فيه اللبنانيون بإصلاح إداري شامِل، يبقى قانون الإنتخابات من أبرز العوائِق التي تعترض بناء دولة مدنية حديثة.
إنَّ قانون “انتخاب أعضاء مجلس النُوَّاب” يكشِف مدى انحِراف النَصّ عن مبادئ الدستور، وتناقُضه مع تطلُّعات الإصلاح الإداري المُعاصِر.
مِن هُنا، تتناول هذه الدراسة تحليلًا مُعَمَّقًا لهذا القانون، وتَعرِضهُ على مَحَكّ التقييم القانوني، السياسي والإداري.
إنَّ مُقترَح القانون بصيغَتِه الحالية يُعيد إنتاج النِّظام القائِم على الطائفية والمُحاصَصة، ويُعيق الوصول إلى إصلاح إداري فعَّال ومُؤسَّساتي. لذلك، لا بُدّ من إدخال تعديلات جوهرية تُحقِّق مبادئ العدالة، المُساواة، والمُساءَلة، بما يُمَكِّن من بناء دولة مدنية قائِمة على الكفاءة والمُواطنة.
غياب مبدأ المساواة التمثيلية والإصلاح الإداري الشَّامِل
يَنُصّ المُقترَح على أن يكون الاقتراع “عامًا وسرِّيًا وعلى أساس النسبية”، إلَّا أنَّ استمرار توزيع المقاعِد على أساس طائفي يتناقَض مع مبادئ الدولة المدنية والمُواطَنة الكامِلة التي يُنادي بها الإصلاح الإداري. الإصلاح الحقيقي يتطلَّب تجاوُز القيد الطائفي وتبنِّي تمثيل قائِم على الكفاءة والبرامج.
تثبيت المركزية السياسية
المُقتَرَح يُبقي لبنان دائرة إنتخابية واحدة، ما يُعزِّز منطق المركزية ويُضعِف دور الأطراف والمناطق الريفية، وهو ما يتناقَض مع مبادئ اللامركزية الإدارية والإنمائية التي نصَّ عليها اتِّفاق الطائف والإصلاح الإداري المنشود.
توزيع المقاعد على أساس الطوائف والمذاهب
تخصيص 128 مِقعدًا وتوزيعها بدقة طائفية لا يتماشى مع مبادئ الحَوكمة الرَّشيدة التي تدعو للفَصل بين الدين والدولة، بل يُكرِّس المُحاصَصة الطائفية التي ثَبُتَ فشلها في إدارة الشأن العام.
توصيات إصلاحية
التحوُّل نحو قانون إنتخابي مدني
يجب تعديل القانون بما يضمَن إلغاء القيد الطائفي في الترشيح والتصويت، وتبنّي معايير تمثيل مدني قائِم على النسبية الجغرافية والعدالة السكانية، بما يُعزِّز الوحدة الوطنية.
دعم اللامركزية الإدارية والتمثيل المناطقي
يُمكِن إعادة النظر بتقسيم الدوائر الإنتخابية وِفقًا للمعايير التنموية والمناطقية لا الطائفية، بما يُعزِّز الإنماء المُتوازِن ويُعطي للمُواطِن دورًا فعَّالًا في الرقابة والمُساءَلة على مُمثِّليه.
تعزيز الحوكمة والشفافية في العملية الإنتخابية
لا بُدَّ من إقرار آليات شفَّافة لإدارة العملية الإنتخابية تشمُل هيئة مُستَقِلَّة للإشراف، ومكنَنَة الإقتراع، وتوفير فُرَص مُتساوية للترشُّح بعيدًا عن المال السياسي والمحسوبيات.
قراءة تحليلية في بُنية القانون
يتكوَّن القانون رقم 44/2017 من سلسلة مواد تُنظِّم الإنتخابات النيابية على أساس النسبية في 15 دائرة إنتخابية، مع اعتماد الصوت التفضيلي ضمن القضاء. ظاهريًّا، يُفترَض أنَّ هذا القانون يُمَثّل تقدُّمًا بالمُقارنة مع النظام الأكثري السَّابِق، إلَّا أن تفاصيله تكشف أنَّهُ أبعد ما يكون عن الإصلاح.
1.1 تقسيم الدوائر والتمثيل غير المُتوازِن
التقسيم الإنتخابي لا يستند إلى معايير سكانية مُوحَّدة. على سبيل المثال، يبلغ عدد الناخبين في دائرة بيروت الثانية أكثر من 180 ألفًا، بينما لا يتجاوز في دائرة زحلة 60 ألفًا. هذا التفاوُت ينسف مبدأ المُساواة في التمثيل المنصوص عليه في المادة 7 من الدستور اللبناني.
1.2 الصوت التفضيلي وتعزيز الزعامات
الصوت التفضيلي، وإن بدا ديمقراطيًّا، يُستخدَم لتفجير التوازُن داخل اللوائح، ويخدُم المُرشَّحين المُرتبطين بآليات الزبائنية. ويخلق تنافُسًا داخليًا يُضعِف قُوَّة اللائحة كفكرة سياسية، ويُحوِّل المعركة إلى لعبة فردية.
1.3 غياب الهيئة المُستقلَّة للإشراف
في مُخالَفة صريحة للمعايير الدولية، يَظَلّ الإشراف على الإنتخابات بِيَد وزارة الداخلية، ما يُشَكِّك في حِياد العملية بِرِمَّتِها. وعلى الرَّغم من النصّ على “هيئة رقابية”، فإنَّ صلاحياتها محدودة ولا تتمتَّع بالإستقلال المالي أو الإداري.
القانون والإصلاح الإداري – منطِقان مُتصادِمان
الإصلاح الإداري لا ينفَصِل عن بيئتِه السياسية. ولكي يكون فاعِلًا، يجب أن يقوم على أساس من الشفافية، فصل السلطات، وتكافؤ الفُرَص. القانون الإنتخابي الحالي يُقوِّض هذه المبادئ على عِدَّة مستويات:
2.1 التعيينات الإدارية والتبعية النيابية
مُنذُ نهاية الحرب الأهلية، ارتَبَطَت التعيينات في الفئة الأولى بالإتِّفاقات السياسية التي تُنسَّج بين الأحزاب المُمَثَّلة في المجلس النيابي. ومع انتخاب مجلس مُشَكَّل على أساس طائفي-سياسي، تُصبِح الإدارات رهينة للتسويات، لا للمعايير الموضوعية.
2.2 غياب المُحاسَبة الإدارية
مجلس النُوَّاب، بحسب الدستور، يُفترَض أن يكون أداة رقابة على عمل السلطة التنفيذية. لكن واقعيًا، يتحوَّل إلى غطاء سياسي لها، خُصوصًا عندما يكون تمثيل الكتل قائِمًا على الولاءات لا البرامِج. بذلك، تُفرَغ آليات الرقابة البرلمانية من مَضمونِها، ويُحرَم المُواطِن مِن حَقِّهِ في إدارة نظيفة وخاضِعة للمُحاسَبة.
2.3 تعارُض مع مبدأ الكفاءة الإدارية
من المبادئ الأساسية في الإصلاح الإداري هو تعيين المُوظَّفين على أساس الكفاءة والخبرة. لكن حين يُنتَخَب النُوَّاب بناءً على الولاء الطائفي لا الرؤية التنموية، فإنَّ التشريع والمُساءَلة والإدارة كُلَّها تُختَزَل إلى أدوات ضمن شبكة المصالِح.
تطلُّعات اللبنانيين – ما بين النُّصوص والواقِع
مُنذ العام 2015، وبشكل أكثر وُضوحًا في حراك تشرين 2019، عبّرَ اللبنانيون عن تطلُّعاتِهِم الواضِحة: دولة مدنيَّة، قانون انتخاب عادل، تمثيل فعلي، وإدارة نظيفة. لكن القانون الإنتخابي الحالي يعكس هُوَةً كبيرة بين ما يُريدُه الناس وما تفرِضُه الطبقة الحاكِمة.
3.1 غياب الكوتا النسائية
المرأة تُشَكِّل أكثر من نصف الجسم الإنتخابي، لكنَّها نادِرًا ما تُنتَخَب. القانون لا يُلزِم اللوائح بترشيح نساء، ولا يُخصِّص لهن مَقاعِد رغم المُطالبَات الواسِعة والمُقارَنة بتجارب عربية مثل تونس والمغرب، حيث أُقِرَّت كوتات إلزامية.
3.2 تغييب الشَّباب وقوى التغيير
تُصاغ اللوائح عادة عبر مُفاوَضات مُغلَقة بين القوى السياسية التقليدية، ما يُقصي المُرشَّحين المُستقلين أو القادِمين من المُجتمع المدني. هذا الإقصاء يُفرِغ مبدأ التمثيل الشعبي من مَضمونِه، ويُبقي “الديمقراطية” شكليَّة.
3.3 تمويل إنتخابي غير مُنضَبِط
رغم وجود سُقوف للإنفاق، إلَّا أنَّ المال السياسي يُهَيمِن على الحَملات، خُصوصًا في الدوائر ذات الطابع الخدماتي. القانون لا يمنَح هيئة الرقابة القُدرة الفعليَّة على التدقيق في مصادر التمويل، ما يُفسِد اللعبة الإنتخابية بِرِمَّتِها.
التبايُن حول القانون – قراءة في أسبابه السياسية والتشريعية
يُظهِر قانون “انتخاب أعضاء مجلس النُوَّاب” أنَّ الخلاف حول القانون ليس خلافًا تقنيًّا بل بُنيويًّا، يرتبط بطبيعة النظام اللبناني نفسه. ويتَّضِح ذلك من خلال نقاط عديدة:
4.1 الطائفية كإطار تنظيمي للقانون
القانون، رغم تبنِّيه النسبية، لم يَخرُج عن القيد الطائفي. لا بل رسَّخَهُ من خلال تحديد المقاعِد سلفًا لِكُلّ طائفة في كُلّ دائرة، ما يجعَل التنافُس محدودًا داخل الإطار الطائفي.
4.2 تكريس الامتيازات التاريخية
بعض القوى السياسية اللبنانية ترى في القانون الإنتخابي الحالي وسيلة لضمان استمرارها في الحُكم، لأنَّهُ يُكرِّس التوازُنات الطائفية والمناطقية التي مكَّنَتها تاريخيًا من البقاء في السُّلطة. ولذلك، فإنَّ أي تعديل جذري على هذا القانون – مثل السَّماح بالتصويت دون التقيُّد بالهُويَّة الطائفية – يُهدِّد هذه القوى لأنَّها قد يُفقِدها نُفوذها التقليدي، ويُعيد توزيع التَّمثيل السياسي بناءً على قواعد أكثر عدالة وتمثيلاً حقيقيًّا للإرادة الشعبية.
4.3 غياب العدالة التمثيلية
أحزاب عديدة تطعَن بتوزيع الدوائر، خُصوصًا في بيروت وجبل لبنان، حيث يبرُز الخلل في وزن الصَّوت الواحِد بين منطقة وأخرى، ما يتعارَض مع مبدأ العدالة الإنتخابية.
نماذج مُقارَنة وقابِلة للتطبيق
يُقارِن القانون بين النظام اللبناني ونماذج عربية ودولية، فيكشف أنَّ كثيرًا من الدول، رغم التنوُّع الإثني أو الديني، نجَحَت في اعتماد قوانين انتخابية مُتوازنة، مثل:
5.1 تونس: قانون انتخابي مدني بالكامل
اعتمَدَت تونس بعد الثورة نظامًا نسبيًا قائِمًا على القوائِم المفتوحة، مع كوتا نسائية إلزامية، وهيئة مُستقلَّة للإشراف على الإنتخابات، مِمَّا عزَّزَ الشفافية.
5.2 العراق: دائرة وطنية مع نسبية مفتوحة
رغم الصِّراع الطائفي، أقرَّ العراق قانونًا انتخابيًا نسبيًا حديثًا بعد 2020، يعتمد التمثيل المناطقي المفتوح، ويُدرِج الشفافية كشرط أساسي.
5.3 فرنسا: نظام مُزدوِج يُوازِن بين التمثيل المحلي والوطني
في فرنسا، يُنتَخَب جزء من النُوَّاب على أساس الدوائر، لكن ضمن إطار حزبي قوي، وَيُخضَعْ النَّائِب لمُساءَلة حزبية وشعبية فعلية.
مُلاحظات دستورية على القانون
القانون الإنتخابي اللبناني يتناقَض مع عِدَّة مواد دستورية أساسية:
المادة 7: تنُصّ على المُساواة بين اللبنانيين، لكن تقسيم الدوائر وصوت كُلّ ناخِب لا يعكس هذه المساواة.
المادة 21: تُعطي لِكُلّ مُواطن الحق بالاقتراع، لكن ممارسته مُقيَّدة بقيود طائفية وإجرائية.
المادة 95: تدعو إلى إلغاء الطائفية السياسية، بينما القانون الحالي يُعيد تكريسها.
القانون بوَّابة للإصلاح… أو أداة لتكرار المنظومة القائِمة؟
يخلص قانون “انتخاب أعضاء مجلس النواب” إلى أنَّ القانون الإنتخابي في لبنان، رغم ما يُظهِرُه من تحديث شكلي، لا يُواكِب مُتطلِّبات العصر ولا يفتح آفاقًا لإصلاح فعلي. بل يُشَكِّل أداة بيد الطبقة الحاكِمة لإطالة عُمر نفوذها، وترسيخ منظومة الزبائنية على حساب تطوير الإدارة ومبادئ العدالة.
فأيّ مشروع إصلاحي إداري، بل أي مسعى لبناء دولة حديثة، لا يمكن أن ينطلِق إلَّا من مُراجَعة شامِلة لهذا القانون، على أساس المُواطَنة لا الإنتماء الطائفي. من دون ذلك، سيبقى الإصلاح شعارًا فارِغًا، وتغدو الدولة مُجرَّد إطار دستوري نظري يفتقر إلى التطبيق العملي والفعالية الواقعية.
إضافات إصلاحيَّة
الفساد الإنتخابي وآليات الحدّ منه:
يُعَدّ الصوت التفضيلي من أبرز أوجُه الخلَل في النظام الإنتخابي اللبناني القائِم حيثُ يُكرِّس المُنافَسة داخل اللائحة الواحدة، ويفتح الباب أمام الزبائنية السياسيَّة، شِراء الأصوات، والضَّغط على النَّاخِبين. ومِن هُنا، فإنَّ اعتماد نظام النسبية الكاملة مع اعتماد صوتين أو ثلاثة بدل الصوت الواحد، أو من دون أصوات تفضيلية، يُمكن أن يُشكّل خياراً أكثر عدالة، يُعزّز تمثيل الإرادة الشعبية بشكل أدق، ويُقلِّص من الإنقسامات الداخلية والصِّراعات الشخصية داخِل اللوائِح.
ولِضَمان نزاهة الإقتراع، يجب تأمين قاعة اقتراع واسعة، بدلًا من تنظيم العملية داخل غُرَف صغيرة (20 م² أو أقل) أو مدارس غير مُهيَّأة، حيث تسمح المسافات الضيِّقة لرئيس القلم أو المندوبين بِمُراقَبَة النَّاخِب، ما يُهدِّد سريَّة الإقتراع. لذا، يُفتَرَض أن تكون المسافة بين النَّاخِب والمُشرفين على العملية الإنتخابية من 5 إلى 10 أمتار، مع وضع فواصِل بصريَّة تضمَن الحياد والخُصوصية داخل المَعزل الإنتخابي.
كما أنَّ إجراء الإنتخابات في يوم واحِد لِكُلّ الدوائر يُعَدّ إجراءً ضروريًّا للحدّ من التجاوُزات، ولضمان المُساواة بين المُرشَّحين والنَّاخِبين. أمَّا في ما يَخُصّ التمويل، فلا بُدَّ من تقسيم الدَّعم العام لِكُلّ مُرشَّح على حِدَة بحسب عدد مندوبيه، وليس لرئيس اللائحة أو الحزب السياسي، مَنعًا لشِراء الذِّمَم أو فرض الوصاية المالية. ويجب تجريم أي عمليَّة دفع مالي يقوم بها رئيس اللائحة للمُرشَّحين مُقابِل تنازلهم عن مندوبيهم أو أصواتهم، باعتبارها رشوة انتخابيَّة يُعاقِب عليها القانون اللبناني بِمُوجِب المادة 62 من قانون الإنتخابات.
في السِّياق نفسه، يجب مَنع أي مُرشَّح مُستقلّ أو غير مُدرَج ضمن لائحة من استخدام أمواله الخاصة لدعم لائحة حزبية أو سياسية، حِرصًا على استقلالية المعركة الإنتخابية. كما ينبغي فرض قُيود صارِمة على العلاقة بين المندوبين ورئيس القلم، مع تفعيل الرقابة لضمان عدم تواطؤ الطَّرَفين في التأثير على النتائج.
وتقتَرِح بعض المراجع الأكاديمية والسياسية اعتماد نظام انتخابي بديل، مثل:
النِّظام النسبي مع لوائِح مُغلَقة بدون صوت تفضيلي، على غِرار النموذج الإسباني.
أو اعتماد نظام التمثيل النسبي مع صوتين تفضيليين على مستوى الدائرة الكبرى، لتوسيع خيار النَّاخِب دون إضعاف تماسُك اللائحة.
إضافةً إلى إنشاء هيئة انتخابية مُستقلَّة بالكامِل (وِفقَ توصيات الأمم المُتَّحِدة) للإشراف على كامِل العملية، بعيدًا عن تدخُّل وزارة الداخلية.
تُعَدّ هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز الشفافية الإنتخابية، ومُحارَبة الفساد، وإعادة بناء ثقة المُواطنين بالمؤسسات الديمقراطية.
ويُعَدّ توظيف المندوبين الإنتخابيين بشكل مُفرَط وغير مُبرِّر أحد الأساليب المُستحدَثة للرَّشوة المُقنَّعة، حيث يتمّ دفع مبالغ مالية ما يفتح المجال أمام شراء ذِمَم النَّاخِبين عبر استمالة المندوب وأفراد مُحيطه الإجتماعي. وتتحوَّل بذلك وظيفة المندوب، التي يُفترَض أن تُمارَس في إطار من الشفافيَّة لحماية نزاهة العملية الإنتخابية، إلى أداة ضغط وتوجيه، داخل مراكز الإقتراع وخارجها، ما يُقوِّض مبدأ السريَّة ويُكرِّس ثقافة الزبائنية السياسية.
وتتفاقَم هذه الظاهرة بِفِعل غياب تنظيم دقيق لآلية تعيين المَندوبين، إذ يَسمَح القانون الحالي لكل مُرشَّح بتعيين وشراء مندوبين ما يؤدي إلى تضخُّم غير مُبرَّر في عدد المَندوبين، بخلاف المُمارَسات الفُضلى المُعتمَدة دوليًا، والتي تُحدِّد مَندوبًا واحِدًا للائحة كَكُلّ. ونتيجةً لذلك، تشهَد أقلام الإقتراع ومُحيطها حالة من الاكتظاظ المَقصود، تُمَهِّد لِخَلق أجواء ترهيب أو استمالة مُبَطَّنة للنَّاخبين، في خَرق مُباشِر لسِريَّة الإقتراع ولمبدأ الحياد.
كما يُساهِم ضُعف تطبيق القوانين والتعاميم ذات الصِّلة من قِبَل الجِهات المعنيَّة، وفي مُقدِّمها وزارة الداخلية، في شَرعَنة وُجود الماكينات الإنتخابية بالقُرب من مراكز الإقتراع، بدلًا من ضبطها. ويُعَدّ تنظيم العملية الإنتخابية في قاعات واسعة ومفتوحة مع الحفاظ على الحواجز البصرية والمسافات الآمِنة، واعتماد نظام المندوب الواحِد للائحة، خطوات أساسية للحدّ من هذا النَّوع من الإنتهاكات وضمان حُرِّية التَّصويت.





